|
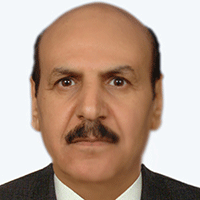
ما يؤرقنا - فوضى لغوية في استعمال الأدوات
أ. دوان موسى الزبيدي
إنّ العربية في عصرنا هذا تعاني من فوضى لغوية في استعمال الأدوات ( حروف الجر ، والعطف ، والاستفهام، والشرط ،وسوى ذلك..) ،ومن أسباب هذه الفوضى الضعف المستشري في العربية، لدى من يُفترض أنّهم من المختصين فيها، قبل أن يكون لدى غيرهم، يضاف إلى ذلك أنّ المؤثرات في الحياة اللغوية خرجت من أيدي المعنيين ،فوسائل الإعلام بشتى أنواعها تنتشر انتشاراً لم تنتشره من قبل، باتت تستخدم تعبيرات ،وأساليب محدثة تخرق القوانين اللغوية ،والنظام اللغوي العربي
والذي دفعني إلى الوقوف عند بعض الاستعمالات الخاطئة لأدوات اللغة ما رأيته من توسّع في استخدام حروف العطف، والجر، ومن خلل في استعمال أدوات الشرط.(إن ،وإذا) فقد ورد في القرآن الكريم ما يبيّن لنا حسن استعمال هذه الأدوات ؛فقوله تعالى: (وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ), لما كانت (الواو) لمطلق الجمع لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً جاء عطف السقيا على الإطعام بالواو لأن لا فائدة من تقديم أحدهما على الآخر، فلولا مراعاة حسن النظم لكان يستوي أن تقدم الإطعام، أو السقيا فيقال: (والذي هو يسقين ويطعمني), لكن حسن النظم يقتضى (وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) لتناسب الآيات؛ لذا لم تستخدم الآية العطف بحرف (الفاء) التي تفيد الترتيب مع التعقيب، ولم تستخدم أيضاً (ثم) التي تفيد الترتيب مع التراخي ،ولما كان الشفاء يعقب المرض بلا زمن خال من أحدهما استخدم حرف العطف (الفاء) التي تفيد وقوع الشفاء بعد المرض مباشرة ؛ولأن المقام مقام مدح وثناء لله رب العالمين أثنى إبراهيم على ربه لسرعة إشفائه بعد مرضه.. ولما كانت (ثم) تفيد الترتيب مع التراخي استخدمها في عطف الحياة على الموت لأن البعث يكون بعد الموت بزمن كبير فناسب أن يعطف الحياة على الموت بحرف (ثم(..
قال تعالى: (قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ* مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ* مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ* ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ* ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ), لما كان تقدير الإنسان تابعاً للخلق ،وملازماً له عطف عليها بالفاء (من نطفة خلقه فقدره), ولما كان بين خلقه في بطن أمه ،وبين إخراجه منه زمناً عطف بـ (ثم) التي تفيد التراخي, وكذلك قوله (ثم أماته) لأن بين خروجه من بطن أمه وموته مدة وزمناً, ولما كان بين الإقبار بعد الموت والنشور زمناً ومدة عطف بـ (ثم), (ثم إذا شاء أنشره) أنظر إلى دقة استخدام الحروف فحقاً إن هذا القرآن معجز في بلاغته!!!.
قال تعالى : (فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً* فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً), لما عطف الله تعالى بالانتباذ على الحمل دلّ على أنه كان مباشرة بعدما حملت توجهت مباشرة إلى مكان المخاض، وهو الطلق، ولمّا عطف المخاض على الانتباذ بالفاء دل على أن الطلق جاءها مباشرة بعد الانتباذ ،فدل ذلك على أن الحمل والوضع كانا في زمن يسير ولو كان لغيرها من النساء لعطف بـ (ثم) الدالة على التراخي والمهلة.. فلعل المطاوعة لا يعطف إلا بالفاء كقولك: أعطيته فأخذ, ودعوته فأجاب.. ولا تقول: أعطيته وأخذ ولا دعوته وأجاب, كما لا يقال: كسرته وانكسر.. وعلى ذلك فإن قوله تعالى: (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ), ليس من باب أفعال المطاوعة إذ قوله (أغْفَلْنَا قَلْبَهُ), هاهنا بمعنى صادفناه غافلاً وليس بمعنى صددناه لأنه لو كان كذلك لكان معطوفاً عليه بالفاء, وقيل: (فاتبع هواه), وذلك لأنه يكون حينئذٍ فعل مطاوعة وفعل المطاوعة لا يعطف إلا بالفاء..
لما كانت (في) تدل على الظرفية وعدم الرفعة والعلو كان الأجدر أن يقول المرء: فلان في ضلال مبين وليس على ضلال مبين.. وقد قال إخوة يوسف لأبيهم: (قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ), أي منغمس فيه قد أحاط بك من كل ناحية, وكذا يقال في ما يشابهه كقولك: فلان في ظلام دامس.. أو لقد سقط في وهرة عميقة, هو في لجة من الخزي والعار.. أما إن كان الأمر فيه رفعة وعلو فيقال: (على) كقول الله تعالى في حق المؤمنين: (أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ), كذلك نقول: (هو على تقوى من الله), (هو على نور من ربه), (هو على الحق المبين) ولا تقل هو في الحق أو في النور أو في التقوى لأن (في) لا تشي بالعلو والرفعة بخلاف (على) التي للاستعلاء.
أماقال تعالى: (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ* وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ* وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ* وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ* وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ* وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ* وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ* وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ* وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ* وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ* وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ* وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ), استخدم القرآن الكريم كلمة (إذا) التي تفيد التحقق والتوقع واليقين لأن كل ما ذكر كائن لا محالة، وحق لا ريب في وقوعه ،وحدوثه.
قال تعالى: (فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى), عبر القرآن بـ (إن) لأنها تفيد الشك والتقليل لأن الذكرى قل من ينتفع بها فكان دخول (إن) عليها دون (إذا) مناسباً.
قال تعالى: (إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً), عبر القرآن بحرف إذا الدال على اليقين لبيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصر الله قادم لا ريب فيه وقد كان.. فقد جاء نصر الله ،وفتحت مكة ،ودخل الناس في دين الله أفواجاً وصدق ربنا العظيم. و قال تعالى: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا), استخدم النظم القرآني الحرف (إن) التي تفيد الشك والقلة أي ما ينبغي على المؤمنين أن يقتتلوا وإن حدث ذلك فهو قليل جداً, ولم يستخدم النظم القرآني الحرف (إذا) لأن (إذا) تفيد الكثرة واليقين فتدل على أن القتال بين المؤمنين شيء معتاد وكثير.
قال تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ), استعمل (إن) هنا لتفيد الشك في صدقهم أي أنهم كاذبون وغير صادقين, والأسلوب القرآني يعرض هنا بكذبهم دون أن يصرح به ولكنه يصل إلى الغرض بطريق غير مباشر.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ), عبر بـ (إن) التي تفيد عدم التحقق أي إن كانت لديكم النية مجرد النية في نصرة دين الله وليس الجزم بذلك فإن الله سينصركم لا محالة. ما أجمل أن نعود إلى القرآن بين الحين والآخر لنستقي من معين نظمه ما يساعدنا على تقويم أساليبنا في الكتابة والنطق أيضا.. وينتقد أحد الباحثين فوضى استخدامنا لحروف الجر؛ إذ يقول:"وجدت حروف الجر في لغتنا المعاصرة قد جرى التوسع فيها، عما عهدته العربية من استعمالات ومعان وتراكيب، ورأيت الموضوع –كما قال ابن جنّي- جديراً أن يوضع فيه كتاب ضخم....". !!
|