|

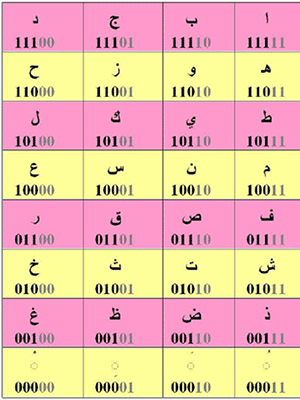
حرف الحاء
م. محمد يحيى كعدان
إن الأداة ( ح 11000 ) تعني عدم معرفة المتكلم (لغياب المستمع) بشكل وصفة العنصر الثاني الحاضر. أي أن العنصر قد "حبا" باتجاه المتكلم، أو أن العنصر "حبّ" المتكلم.
إن الصيغة: " حاء " تعني أن عنصراً واسع التآلف قد حبا للمتكلم (ح ، ا ، ء)، أي لدينا حَبو لعنصر عند المتكلم لعنصر واسع التآلف (لتكرار الألف في الصياغة). والحبو في لسان العرب هو الاقتراب. وغياب الشكل رغم الحضور والاقتراب يدّل على تغيّر شكل المقترب فيصبح شكله الأصلي غير معروف.
يقول ابن منظور في اللسان أيضاً: "حأحأ: حَأحَأ بالتيس: دعَاه. وحِئ حِئ: دعاء الحمار إلى الماء، ..."
الصياغة بالأداة " حين ":
لنتأمل الصيغة التالية كمثال: "حين جاء زيد"، ندرسها وفق المراحل: "ح(ي(ن(جاء زيد)))".
الصيغة "جاء زيد": هي صيغة عنصر عام غائب معروف الشكل للمتكلم ( ن 10010 )، ثم يتعرّف المتكلم والمستمع على شكل هذا العنصر الغائب ( ي 10110 )، ثم يحضر هذا العنصر مع غياب شكله وصفته بالنسبة للمتكلم ( ح 11000 ).
أي أننا أمام عنصر غير معروف (شكلاً أو صفة) يحضر أمام المتكلم (ح) لعنصر غائب معروف الشكل بالنسبة للمتكلم والمستمع (ي)، بعد أن كان غائباً ومعروف الشكل بالنسبة للمتكلم (ن).
وجدنا في مقالنا عن حرف الدال أن ( د 11100 ) تعني اندلال المتكلم والمستمع إلى مكان العنصر، فالكل هنا حضور، أما ( ح 11000 ) فهي حضور للعنصر والمتكلم فقط، أي في طرف من أطراف الصياغة وعند المتكلم تحديداً، وبالتالي فالصيغة "حد" تتحدث: عن عنصر حاضر تمت الدلالة على مكانه (د)، هو منزاح إلى أحد أطراف الصياغة أي هو حضر عند المتكلم (ح).
أما الصيغة "رد" فتتحدث: عن عنصر حاضر تمت الدلالة على مكانه (د)، هو منزاح إلى أحد أطراف الصياغة وهو المستمع ( ر 01100 ).
نحن دوماً أثناء الصياغة نتحدث عن طرفين متقابلين حقيقة أو حكماً.
فالصيغة "عد" تتحدث: عن عنصر حاضر تمت الدلالة على مكانه (د)، وهو يغادر (يعود) إلى أحد أطراف الصياغة إلى المتكلم ( ع 10000 ).
والصيغة "غد" تتحدث: عن عنصر حاضر تمت الدلالة على مكانه (د)، وهو يغادر (يغدو) إلى أحد أطراف الصياغة إلى المستمع ( غ 00100 ).
الأداة ( ي 10110 ) تعني أن المتكلم والمستمع أمام شكل ما مستقل عن أي عنصر (لغيابه، 0 مكان العنصر الثاني).
بينما الأداة ( ن 10010 ) تعني أن هذا الشكل لدى المتكلم فقط، بالتالي نستخدم الأداة (ن) دوماً أثناء التعريف وتقديم الذات، مثل: نا، أنا، نحن، ...إلخ، فالمتكلم ناء (نتيجة حَمله لعنصر متشكل إذا صح التعبير).
بينما الأداة ( ض 00110 ) تعني أن هذا الشكل لدى المستمع فقط، بالتالي نستخدم الأداة (ض) (ضاد) ضدّ التعريف، لأنها في الطرف المقابل للصياغة.
الصياغة بالأداة " حيث ":
لنتأمل الصيغة التالية كمثال: "حيث جلس زيد"، وندرسها وفق المراحل: "ح(ي(ث(جلس زيد)))".
الصيغة "جلس زيد": هي صيغة صفة لعنصر حاضر ( ث 01001 )، ثم يغيب هذا العنصر ويتعرّف المتكلم والمستمع على شكله ( ي 10110 )، ثم يحضر مع غياب شكله وصفته بالنسبة للمتكلم ( ح 11000 ).
أي أننا أمام عنصر غير معروف (شكلاً أو صفة) يحضر أمام المتكلم (ح) بعد أن كان غائباً ومعروف الشكل بالنسبة للمتكلم والمستمع (ي)، بعد أن كان صفة لعنصر حاضر (ث).
الأداة ( ث 01001 )، تعني حضور عنصر موصف، بينما الأداة ( ت 01010 ) فتدل على حضور عنصر متشكل.
يمكن استخدام ( ت 01010 ) في الإشارة لدلالتها على شكل لعنصر حاضر، كما في نقش النمارا، في بادية الشام، وهو كما قلنا سابقاً، نقش من البازلت على قبر الملك امرئ القيس المتوفى سنة 228 م، هذا الحجر محفوظ في متحف اللوفر بباريس. نص السطر الأول منه هو التالي:
" تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج "
ويعني: هذا جثمان امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب كلها، الذي حاز التاج.
فالأداة "تي" تفيد الإشارة (الحديث عن) ( ت 01010 )، لشكل ( ي 10110 ) كان غائباً.
الصياغة بالأداة " حتّى ":
" حتّى "، أداة مركّبة من الأداتين: " حتْ " و " تا ".
أي أننا أمام عنصر غير معروف (شكلاً أو صفة) يحضر أمام المتكلم ( ح 11000 )، لعنصر متشكّل حاضر ( ت 01010 )، لعنصر متشكّل حاضر ( ت 01010 )، لعنصر متآلف ( ا 11111 ).
الصياغة بالأداة " حاشا ":
أي أننا أمام عنصر غير معروف (شكلاً أو صفة) يحضر أمام المتكلم ( ح 11000 )، لعنصر متآلف ( ا 11111 )، لعنصر حاضر متشكّل وموصّف ( ش 01011 )، لعنصر متآلف ( ا 11111 ).
الصيغ " دَلْ ، حَلْ ، رَلْ ، لَلْ ":
ما يُميّز الصيغ السابقة غياب الشكل والصفة في القوالب الرقمية التي تُعرّفها، لوجود القيم ( 00 ).
لتكن الصيغة: (دَلْ). تعريف الدال هو 11100، واللام هو 10100، وتعني:
عدم معرفة المتكلم والمستمع لشكل وصفة عنصر حاضر (د)، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع (ل). هذا يعني اندلال (من الدلالة) المتكلم والمستمع، على عنصر غير معروف الشكل والصفة لهما.
لتكن الصيغة: (حَلْ). تعريف الحاء هو 11000، واللام هو 10100، وتعني:
عدم معرفة المتكلم فقط لشكل وصفة عنصر حاضر (ح)، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع (ل). هذا يعني أننا أمام عنصر غير معروف (شكلاً أو صفة) يحضر أمام المتكلم (ح). وهذا العنصر الذي حضر عند المتكلم، هو حلّ ما (لمشكلة مثلاً).
لتكن الصيغة: (رَلْ). تعريف الراء هو 01100، واللام هو 10100، وتعني:
عدم معرفة المستمع فقط لشكل وصفة عنصر حاضر (ر)، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع (ل). هذا يعني أننا أمام عنصر غير معروف (شكلاً أو صفة) يحضر أمام المستمع مبتعداً عن المتكلم. هذا الحضور أمام المستمع، هي تورية بالنسبة للمتكلم. فإذا كانت الصيغة: (حَلْ)، هي حضور عنصر أمام المتكلم، فإن الصيغة: (رَلْ)، هي تورية هذا العنصر عن المتكلم.
وهكذا فإن الصيغة: (حَلا)، هي اندلال المتكلم فقط على عنصر متآلف مع المتكلم والمستمع (نتيجة وجود الألِف). أما الصيغة: رَلا (رَلَى)، تورية عنصر متآلف مع المتكلم والمستمع عن المتكلم فقط.
ملاحظة : إنّ مادة (رَلْ) ، (رَلَى) غير موجودة في لسان العرب أو المنجد.
بالمناسبة إنّ الصيغة: (رَ)، تعني عدم معرفة المستمع لشكل وصفة عنصر حاضر؛ هي نوع من الدلالة، لأنها تفيد كما هو معروف نظر المستمع إلى عنصر حاضر، ولكنه غير معروف الشكل والصفة له؛ وبالمقابل فإن: (رَ)، كأمر من المتكلم إلى المستمع، يدل على تواري العنصر عن المتكلم أو استقلاله عنه بالصياغة، لغياب المتكلم عن الصيغة حسب القيم في تعريف الصيغة: ( رَ 01100 ).
لتكن الصيغة: (لَلْ). تعريف اللام هو 10100، وتعني:
عدم معرفة المتكلم والمستمع لشكل وصفة عنصر غائب (ل)، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة للمتكلم والمستمع (ل). وبالتالي فنحن أمام عدم تعرّف المتكلم والمستمع على عنصر غائب، لعنصر غائب غير معروف الشكل والصفة لهما.
|
|
|
|