|
|
|
|
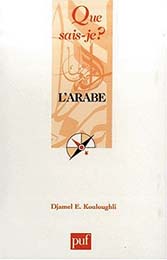
اللغة العربية
مؤلف هذا الكتاب هو الباحث الفرنسي من أصل مغاربي جمال الدين كوغولي، وهو مدير قسم اللغة والدراسات العربية في المعهد القومي للبحوث العلمية الفرنسية. وكان قد نشر سابقا عدة كتب نذكر من بينها: قواعد اللغة العربية المعاصرة. وبالتالي فالرجل مختص في الدراسات اللغوية وفقه اللغة العربية. ومنذ بداية كتابه يقول ما معناه:كل اللغات الكبرى للثقافة البشرية لها مغامراتها التاريخية الخاصة. ولكن مغامرة اللغة العربية، أو بالأحرى قدرها ومصيرها، يتبدى لنا شديد الخصوصية والغرابة. فهذه اللغة لم تكن في البداية إلا لغة بعض قبائل البدو الرحل.
ولكنها تحولت خلال فترة قصيرة بعد الفتوحات الإسلامية إلى لغة عالمية للفكر والعلم والثقافة. وأخذت تستوعب الميراث الحضاري والعلمي والفلسفي لكل الحضارات السابقة من فارسية، أو هندية، أو بالأخص الإغريقية. وكل ذلك حصل خلال قرنين أو ثلاثة من الزمن فقط. وبالتالي فلولا ظهور الإسلام لما تعدت اللغة العربية حدود شبه الجزيرة العربية ولظلت لغة البدو الرحل: أي لغة الشعر الجاهلي فقط. ولكنها تجاوزت كل ذلك لكي تصبح اللغة العالمية الأولى للعلم والفلسفة: من رياضيات، وهندسة، وعلم فلك، وبصريات، وفيزياء، وكيمياء، ومنطق، وميتافيزيقيا، الخ. لقد أصبحت الأداة اللغوية لأكبر حضارة في العصور القديمة.
ولم تكن مكانتها إبان العصر الذهبي من عمر الحضارة العربية الإسلامية تقل عن مكانة الإنجليزية اليوم. والدليل على ذلك هو أن علماء أوروبا المسيحية في اسبانيا وسواها راحوا يتعلمونها لكي يستطيعوا نقل كتب الفلسفة والعلوم إلى لغتهم اللاتينية ويبنوا على كل ذلك صرح حضارتهم المقبلة.وكان مثقفو أوروبا في ذلك الزمان يفتخرون بأنهم يعرفون العربية مثلما نفتخر نحن الآن بأننا نعرف الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أي لغة حضارية حديثة أخرى.
ثم يردف الأستاذ جمال الدين كوغولي قائلا: إن العربية اليوم هي رسميا لغة أكثر من عشرين بلدا، أي لغة ما يقارب الثلاثمئة مليون نسمة. ويمكن أن تصبح لغة نصف مليار شخص حوالي منتصف القرن الحادي والعشرين، أي عام 2050. وبالتالي فمستقبلها أمامها لا خلفها بشرط أن يزودها الباحثون العرب بالأدوات الضرورية لتفتحها وازدهارها: أي أن ينقلوا إليها كل العلم الحديث لكي تتوسع معانيها وتراكيبها وتتزايد مصطلحاتها ومفاهيمها عن طريق الترجمات الكبرى.
يضاف إلى ذلك أن اللغة العربية هي إحدى اللغات الأساسية المعتمدة في الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية الكبرى المتفرعة عنها أولا. وهي بذلك اللغة الوحيدة غير الأوروبية التي تتمتع بهذا الامتياز بالإضافة إلى اللغة الصينية: لغة مليار ونصف المليار شخص. ولا ينبغي أن ننسى أن العربية، بما أنها لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي والشعائر والطقوس، فإنها تهم مليارا ونصف المليار من المسلمين. صحيح أنهم لا يتقنونها جميعهم ولكنهم يؤدون طقوسهم وشعائرهم وصلواتهم بها حتى لو لم يعرفوها جيدا.
ثم يقدم المؤلف بعدئذ دراسة تاريخية عن نشأة هذه اللغة العريقة وتطورها خلال العصور. ولذلك فإنه يقسم كتابه إلى سبعة فصول. في الفصل الأول يتحدث عن اللغات السامية التي تنتمي إليها اللغة العربية. من بين هذه اللغات يمكن أن نذكر الآشورية، والآرامية لغة السيد المسيح، والفينيقية، والعبرية لغة التوراة واليهود. هذا بالإضافة إلى لغات أخرى.
وأما الفصل الثاني من الكتاب فمكرس لدراسة كيفية ظهور اللغة العربية قبل الإسلام. هذا في حين أن الفصل الثالث يتحدث عن كيفية تشكل اللغة العربية الكلاسيكية. وهنا يقول المؤلف ما معناه: لقد تشكلت هذه اللغة بدءا من القرن الثامن الميلادي بناء على دراسة نصين أساسيين هما: نص القرآن الكريم، ونص الشعر الجاهلي السابق على الإسلام. فاللغة الكلاسيكية، أو الفصحى، تشكلت من خلال تقليد هذين النصين الكبيرين. والشعر الجاهلي لم يكتب في الواقع قبل بداية القرن التاسع الميلادي، أي بعد ثلاثة أو أربعة قرون من ظهوره. وأما قبل ذلك فكان يحفظ بشكل شفهي جيلا بعد جيل من خلال رواة محترفين. وإذن فهناك فرق بين المرحلة الشفهية والمرحلة الكتابية.
وأما في الفصل الرابع من الكتاب فيتحدث المؤلف عن كيفية بلورة اللغة العربية الفصحى. وهنا يقول ما معناه: في القرن الذي تلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع العرب أن يغلبوا الفرس والروم ويشكلوا إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف. إنها تمتد من حدود الهند والسند شرقا إلى اسبانيا غربا. وبما أن سكان هذه المناطق المفتوحة كانوا مضطهدين من قبل أسيادهم السابقين، أي الروم الفرس، فإنهم رحبوا عموما بالفاتحين الجدد. فقد خلّصوهم من دفع الضرائب الباهظة وأنقذوهم من الاضطهاد على أساس ديني، وذلك لأنهم كانوا يتبعون مذهبا مسيحيا مخالفا لمذهب الإمبراطورية البيزنطية.
ثم يردف المؤلف قائلا: مهما يكن من أمر فإن العرب البدو وجدوا أنفسهم فجأة أمام شعوب ضخمة ومناطق شاسعة. وكان عليهم أن يترأسوها ويديروا أمورها بصفتهم الحكام الجدد لبلاد سوريا ومصر وفلسطين والعراق، الخ. وكان معظم سكان هذه البلدان من الفلاحين المستوطنين لا البدو الرحل. بل كانت توجد عواصم حضارية كبرى في هذه المناطق المفتوحة ليس أقلها دمشق، أو المدائن، أو الاسكندرية. ولم يكن عرب الجزيرة العربية مهيئين لتسلم رئاسة كل هذه الشعوب والبلاد. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا أقلية وسط هذه الشعوب المفتوحة الغزيرة العدد.
وبالتالي فكان هناك خطر من أن يذوبوا لغويا وثقافيا وحضاريا في خضم هذه الشعوب الأكبر عددا منهم بكثير. ولكن قادة الفتوحات الذين لمحوا هذا الخطر فورا اتخذوا بعض القرارات الأساسية التي أنقذت العرب واللغة العربية. من بين هذه القرارات تشكيل مدن خاصة بالعرب فقط، كالكوفة، والبصرة في العراق، والفسطاط في مصر، والقيروان في تونس، الخ. وبالتالي فعلى الرغم من أن العرب كانوا أقلية في كل مناحي الإمبراطورية ما عدا الجزيرة العربية بالطبع إلا أنهم كانوا دائما أكثرية في مناطق تجمعهم المذكورة.
وحدها سوريا كانت مستثناة من هذه السياسة لأنها كانت مسكونة سابقا من قبل العرب على الأقل بشكل جزئي.ثم يتحدث المؤلف بعدئذ عن إصلاح الكتابة العربية، وظهور التنقيط للتمييز بين الحروف المتشابهة، ثم ظهور علم قواعد اللغة العربية. وأما الفصل الخامس من الكتاب فمكرس لدراسة الإمبراطورية العربية في عصرها الذهبي.
وهنا يقول المؤلف ما معناه: إن الفترة الممتدة من القرن التاسع الميلادي إلى القرن العاشر شهدت ذروة القوة السياسية الاقتصادية والثقافية للإمبراطورية العربية ـ الإسلامية. فبدءا من تلك اللحظة أصبحت الحضارة الجديدة مزودة بأداة لغوية متقنة وفعالة هي اللغة العربية. ولم يعد العرب يحسدون كبريات الحضارات السابقة على لغاتها. وعندئذ أخذت الفصحى كل أبعادها وبرهنت على إمكانياتها في التعبير عن الشعر والنثر والفلسفة والعلوم التجريبية في آن معا.
وعندئذ ظهرت المؤلفات الكبرى التي ستشكل مجد التراث العربي الإسلامي. ولكن في ذات الوقت شهدنا ظهور الاستقطاب اللغوي في المجال العربي. فمن جهة كانت هناك اللغة الفصحى، لغة الكتابة والتراث والفقه والدين والعلم والفلسفة. ومن جهة أخرى كانت هناك اللهجات المحكية التي تختلف باختلاف البلدان والمناطق. وسوف تظل هذه الظاهرة مستمرة حتى يومنا هذا.
وأما الفصل السادس من الكتاب فيتخذ العنوان التالي: الذروة والانحدار. وهنا يتحدث المؤلف عن دخول العرب في عصر الانحطاط ومدى تأثير ذلك على لغتهم وآدابهم وفكرهم. وأما الفصل السابع والأخير من الكتاب فمكرس لدراسة وضع اللغة العربية في العصور الحديثة وكيف انبعثت من رقادها في عصر النهضة بعد المرور بعصور الانحطاط الطويلة.
*الكتاب: اللغة العربية
*الناشر: المطبوعات الجامعية الفرنسية ـ باريس 2007
*الصفحات : 127 صفحة من القطع الصغير
البيان
|
|
|
|
|
|